 حمزة المفتشعضو نشيط
حمزة المفتشعضو نشيط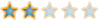
- عدد الرسائل : 106
البلد :
نقاط : 173
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 25/04/2010
 أخـطاء.......
أخـطاء.......
الخميس 10 مارس 2011, 21:14
أخـطاء
د. عائض القرني
هذه مجموعة من الأخطاء ، التي يقع فيها الناس في زماننا ، ذكرتها متتالية ، وعقبت عليها بالحكم الشرعي لها ، محبة مني في أن يجتنبها إخواني المسلمون ، لكي تصفوا عقائدهم ، ويستقيم إيمانهم ، فإليكم إياها متتالية :
منها : أخطاء في الزيارة ، وعدم التقيد بما ذكر الله في كتابه ، وبما سنه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في الزيارة ، بل أصبح في نظام الزيارة عشوائية ، وكدر على الزائر والمزور ، والله ذكر الزيارة في سورة النور ، وبين الأوقات التي تكره فيها الزيارة ( ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ) (النور: من الآية58) فهذه الأوقات محظورة الزيارة فيها ، وهذه الأوقات ، هي : وقت استجمام وراحة ، وهي أوقات خاصة للمسلم مع أهله في بيته ، وليس من الحكمة أن تزوره قبل الفجر .
أسمعت غبياً أو أحمق يطرق عليك قبل الفجر ؟ فتفتح له : ماذا تريد ؟ قال : عندي مسألة ، أو أريد أن أتحدث معك ، يا له من حديث ما أسوده !! من وقت ما أعكره !! أهذا وقت ؟
وبعد صلاة الظهر ( وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) (النور: من الآية58) انظر إلى تعبير القرآن ، حين تأتون من الأعمال منهكين ، عليكم من الكلال والمشقة ما الله به عليم ، فتضعون الثياب ، وترتاحون قيلولة فيطرق الطارق ليبحث في مسألة ، وكم يتعرض الإنسان لمثل هذا الأمر ؟ .
ونحن نتقيد بالكتاب والسنة في جميع أمورنا ، واتصالنا ، وجلوسنا ، وصلاتنا ، وتؤخذ كلها من مشكاة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
فبعد الظهر ، لا زيارة إلا أن تكون هناك وليمة ، أو عزيمة ، أو دعوة ، أو جدول عملي مرتب فلا بأس بها .
( وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ) (النور: من الآية58) وهذا لا يزار فيه ، وإنه لوقت أذهبه كثير من الناس في السهر المضني ، والضياع ، وعدم التحصيل ، والسهر الذي فوت على الكثير منهم صلاة الفجر .
وإني أدعو إخواني إلى أن يكون وقت زيارتهم من بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ، وهو وقت مستهلك ، وبسيط ، وسهل على الزائر والمزور .
وبعض الناس إذا زار أثقل في الزيارة ، يزور بعد العصر ، ولا يخرج إلا في آخر الليل .
رأى الشافعي رجلاً زاره ، وكان ثقيلاً ، فقال الشافعي : ( رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ)(الدخان:12) وكان الأعمش يقول : إني لأسمع بالثقيل ، فتتمايل بي الأرض ، أي أظن أن الأرض تكاد أن تخسف من جهته .
وقال ابن الرومي في زائر زاره :
أنـت يـا هـذا ثـقـيـل وثـقـيل وثـقـيَل أنـت في المـنظـر إنسـان وفي المخـبر فيل
ونحن نقول لإخواننا : أنتم مسلمون ، وموحدون وأحباب ، وعلى المقل ، وطأوا على شغاف القلب ، لكن في أوقات يرتاح فيها العبد ليأتي إليكم بصفاء ذهن .
لأن العبد ، وخاصة من يتلقى أمور الناس ، كالأئمة ، والخطباء ، والقضاة ، والمشايخ ، والمسؤولين ، وأعيان الناس ، دائماً عليهم من المشاكل ما الله به عليم ، فإذا بقى في وقت راحته مشغولاً من الناس فلن يجد وقت راحة .
ومنها : الحلف بغير الله وهو متفش كثيراً في بعض الأماكن ،كأن يقول ( وحياتك ) ( وشرفي ) (ونجاحي) فمن فعل ذلك ، فقد باع حظه من الله ، وقد أشرك ، قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو لبصمت )(1) وقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم )(2) ، فلا يحلف أحد بغير الله الواحد الأحد .
فهو سبحانه العظيم ؛ لأن الحلف تعظيم ، قال ابن مسعود فيما صح عنه : ( لأن الحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً ) ؛ لأن الحلف بالله كاذباً معصية ، والحلف بغيره صادقاً شرك ، والشرك أكبر من المعاصي ، وأكبر الكبائر ، فاستعيذوا بالله من الشرك ظاهراً وباطناً .
وهذا من عدم توقير الله في قلوبهم ، ومن التعدي على حرمات الله وشعائر الله ، ولا يعظم حرمات الله إلا متقي ولا يعظم شعائر الله إلا من في قلبه تقوى . فالواجب على العبد أن يقدر ما في هذا الكلام .
ومنها : الحلف بالطلاق ؛ وهو منتشر ، وقد عظم بعض الناس هنا اليمين به على اليمين بالله بل جعلوه في الولائم ، والمناسبات ، والحضر ، والمنع ، والطلب ، وفي الأمور النسبية والعلاقات فيما بينهم أعظم من الحلف بالله ، بل أحدهم لا يجيب طلبه لأخيه إلا إذا حلف له بالطلاق !
وهذا عند بعض العلماء أنه أقسم بغير الله ، وأشرك ، وعند بعضهم أنه حلف ، وانعقد به الطلاق ، وعند بعضهم أصبح يميناً يقوم به الكفارة . ولسنا نحن في تفصيل الطلاق هنا ، لكن في التحذير من الحلف بالطلاق ، وعدم استخدامه على اللسان ، وما يفعل ذلك إلا من عدم الفقه في الدين ، أو صغرت معلوماته ، بهذه المسألة الضخمة التي استخدمها كثير من الناس .
ومنها : قولهم ( انتقل إلى مثواه الأخير ) يموت ميت فيقولون : انتقل إلى مثواه الأخير ، وهذه الكلمة ، فيما أعلم ، كلمة لبعض الزنادقة من زنادقة المتصوفة ، بل زنادقة الفلاسفة ، الذين كانوا يقولون : القبر هو آخر مثوى ، وهي من الأقوال التي نسبت لابن سينا ، الضال ، الذي هو محسوب علينا ، ومحسوب على بعض المسلمين ، وليس محسوباً على علماء المسلمين ، والله يتولى أمره ، وقد تعرض له ابن تيمية فقصم ظهره في أكثر من موطن .
بل قال مسائل كفره بها الغزالي في ( تهافت الفلاسفة ) ، وقال عنه ابن تيمية في بعض المسائل : إن كان صح عنه ما يقول ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
فقولهم : ( انتقل إلى مثواه الأخير ) أخذها بعض الصحفيين تقليداً فقالوا : إن فلاناً انتقل إلى مثواه الأخير .
والقبر ليس مثوى أخير ، بل المثوى الأخير ، هو : الجنة أو النار ، ( فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) (الشورى: من الآية7) ومقصود الزنادقة : أن يقولوا : لا حياة بعد القبر كما قال عمر الخيام :
فـمـا أطـــال الـنـوم عـــمـراً ومـتا قـصـر فـي الأعـمـار طـول الـســهـر
لـبـسـت ثـوب الـعـمـر لـم أسـتـشـر وطـفـت فـيـه بـيـن شـتـى الـصــور
ثم يذكر في القصيدة : أن القبر آخر مستقر ، وكذب عدو الله ، ليس القبر آخر مستقر ، فبعد القبر حياة ، إما في الجنة ، ,إما في النار ، وبعد القبر : جنة عرضها السماوات والأرض ، أو نار تلظى ، وبعد القبر حساب ، وصراط وميزان ، وتطاير صحف ، وأنبياء ، وشفاعة ، وملائكة ، وبعد القبر : يوم يشيب له الولدان .
فليعلم أن هذه الكلمة خاطئة .
ومنها : قولهم في المناسبات ( فلان غني عن التعريف ) فإذا قدموا لشيخ ، أو داعية ، أو محاضر ، أو مسؤول ، قالوا : فلان علم غني عن العريف .
وهذه كلمة خطأ ، فالغني عن التعريف ، هو : الله ، وهو الذي عرف نفسه بنفسه ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) (الأنعام:1) ، ( الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (فاطر:1) ، فالغني عن التعريف ، هو : الله عرف نفسه لموسى ، فقال : يا موسى ( إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (طـه:14) ، ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً) (مريم: من الآية65) .
وفـي كــــــــل شــيء لــه آيــه تــدل عــلــى أنــه واحـــد
فـيـا عـجـبـاً كـيـف يـعـصـي الإلـه وكـيـف يـجــحــده الـجـاحـد
وما منا من أحد ، إلا ويحتاج إلى تعريف ، ملكاً كان ، أو أميراً أو وزيراً ، أو عالماً ، أو موظفاً ، أو مسؤولاً ، هو : لابد أن يعرف .
وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن وفد عبد القيس قدموا على الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال : ( من القوم ؟ ) أو : ( من الوفد ؟ ) قالوا : من مضر . قال : ( مرحباً بالقوم ـ أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى ) ؟(1) ؟
وفي صحيح البخاري عن جابر قال : استأذنت على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( من ؟)
قلت : أنا .
قال : ( أنا ..أنا ) . كأنه كرهه(2) .
قل من أنت ( لأن أنا ) مجهول ، فكل أحد يقول : أنا لكن سم اسمك .
ولما كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مع جبريل في ليلة المعراج ، طرق باب السماء فقالوا : ( من ؟ قال : جبريل .
قالوا : ومن معك (1) ؟
قال : محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
قالوا : مرحباً بك وبمن معك ) .
وطرق أبو ذر على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من ؟) .
قال : أبو ذر .
فكلنا محتاج إلى تعريف .
قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) (الحجرات: من الآية13) .
ومن الأدب في الإسلام : أنك إذا نزل بك ضيف ، أو وفد : أن تسألهم عن أسمائهم ، ولا تبقى معهم أبكم أصم أعمى .
قال الأسدي :
أحـادث ضـيـفـي قـبـل إنـزال رحــله ويـخـصـب عـنـدي والـمـكـان جديـب
ومـا الخـصـب للأضـيـاف أن يكثر القرى ولـكـنـما وجـه الـكـريـم خـصـيــب
يقول أنا من صفتي أن أحادث ضيفي ، وهو على الراحلة ، فكيف إذا نزل ؟ ولذلك من أدب الضيافة أن تحدثه وتؤانسه ، قال الله لما كلم موسى ( وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى) (طـه:17) وهي من المحادثة والأنس ، فالله يعلم أنها عصا ، فهو الذي خلقها ـ سبحانه وتعالى ـ ويعلم بموسى وفرعون والعصا ، ولكنه تعالى يريد مؤانسة موسى لئلا يخاف .
ومنها : وقد سمعتها من بعض الناس في دعائهم قولهم : ( الله لا ينسانا ولا يقصانا ) وهل الله ينسى؟ ( فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى) (طـه: من الآية52) .
نعم ورد في القرآن : ( قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) (طـه:126) ، ( فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ) (لأعراف: من الآية51) ، والنسيان هنا عند العرب في لغتهم بمعنى الترك يعني : تركهم ، لا أنه نسيهم ، وغفل عنهم . فقول القائل : الله لا ينسانا ليس بصحيح، أو : ربي لا تنساني .
سبحان الله ! خلقك ، وصيرك ، وأحياك ، وأماتك ، ورزقك ، ثم ينساك ، جل الله عن النسيان .
والنسيان صفة نقص ، لا تنسب له ، سبحانه وتعالى ، لا تقييداً ولا إطلاقاً ، وتنفي عنه ، فهو لا ينسى ، تبارك وتعالى ، ولا ينام ، ولا يسهو ، ولا تأخذه سنة ، ولا يحتاج إلى الطعام ، لا يطعم ، سبحانه وتعالى ، وهو يطعم .
وابن تيمه يذكر في كتابه ( درء تعارض النقل والعقل ) وغيره أن الصفات عند أهل السنة على أربعة أقسام :
1- صفات نثبتها مطلقاً لله .
2- وصفات ننفيها عن الله مطلقاً .
3- وصفات نثبتها مقيدة .
4- وفات نستفصل فيها .
فأما الصفات التي نثبتها لله : فهي الصفات ، التي أثبتها الله لنفسه، وأثبتها له رسوله ( صلى الله عليه وسلم) وهي صفات كمال مطلقة ، مثل الحكيم ، العليم ، الواحد ، الأحد ، وأمثالها فهذه نثبتها لله مطلقاً .
وأما الصفات التي ننفيها مطلقاً : فهي ما نفاها ـ سبحانه وتعالى ـ عن نفسه ، وما نفاها عنه رسوله (صلى الله عليه وسلم ) مثل : السهو ، والنسيان ، والغفلة ، والنوم ، والحاجة ، والولد ، والصاحب ، فهذه ننفيها مطلقاً .
وأما الصفات التي نثبتها مقيدة : فهي التي ذكرها الله في القرآن مقيدة مثل : ( فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ) (التوبة: من الآية79) فنقول : الله يسخر بمن يسخر به ، سخرية تليق ، بجلاله ، مقيدة ، غير مطلقة فلا نقول : هو ساخر .
وكقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ(14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ) (البقرة:14- 15) فنقول : يستهزئ الله بمن يستهزئ به ، مقيدة ، لا نثبتها مطلقة .
وكقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ) (لأنفال: من الآية30) فنقول : الله يمكر بمن يمكر به ، مقيدة ، لا أنه يمكر دائماً .
وكقوله سبحانه : ( يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) (النساء: من الآية142) فالله يخدع من خادعه وليس يخدع مطلقاً ، لكن مقيداً بمن خادعه .
وانظر إلى قوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ) (لأنفال : من الآية71) ما قال: خانهم ؛ لأن صفة الخيانة: نقص ، سواء أطلقت، أو قيدت ، فلم يأت بها ـ سبحانه وتعالى ـ فليعلم ذلك ، وهذه قاعدة تكتب بماء الذهب ، وبيض الله وجه شيخ الإسلام يوم حررها .
وأما الصفات التي نستفصل عنها : كصفة الجسم ، فنقول للواصف : ماذا تريد بالجسم أو الجوهر أو التميز؟ فإن كان حقاً أقررنا ، وإن كان باطلاً رددناه عليه ، وهكذا كل ما لم يرد في الكتاب والسنة إذا أطلقه أحد على الله ـ تبارك وتعالى .
ومنها : وهي من الألفاظ ، التي انتشرت بين الناس ، خاصة في الصحف ، قولهم : ( المرحوم فلان ، والمغفور له ) ولا يعلم السر إلا الله ، ولا يعلم نتائج الناس إلا الله ، ولا نشهد لأحد بجنة ، أو نار ، إلا من شهد له رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، لكننا نسأل الله الجنة للطائعين ، ونثني على الصالحين ، وندعوا لهم ، أما أن نقول : (المرحوم ) فهذا خطأ وما يدريك أهو مرحوم أم لا ؟ فلعله من أهل النار .
والأفضل : أن نقول للمسلم إذا مات : فلان غفر الله له ، فلان رحمه الله ؛ لأن هذا من باب الإنشاء ، لا من باب الخبر ، وأجاز أهل العلم الإنشاء ، ولم يجيزوا الخبر ؛ لأنك إذا قلت : المغفور له تخبر ، والخبر عن الله من علم الغيب .
وأما رحمه الله فهو : من باب الدعاء ، وهو إنشاء ، ويجوز إنشاء ، ولا يجوز خبراً ، فليعلم ذلك .
ومنها : قولهم : (فلان شهيد ) نحن نرجو لمن مات في سبيل الله ، أن يكون شهيداً ، ولذلك عندما مات عثمان بن مظعون كما في ( صحيح البخاري ) قال الناس : هنيئاً له من أهل الجنة ، غضب رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وقال : ( أنا ,أنا رسول الله ، والذي نفسي بيده لا أعلم ما يفعل بي )(1) فالعلم عند الله ، لكن نشهد للصالحين كمن يعاود المسجد خمس مرات في اليوم ، والصادق الصالح المنيب ، بار الوالدين ، وصول الرحم ، فهذا نثني عليه ، نحن شهداء الله في أرضه .
ومنها : قولهم ( لقيته صدفة ) وليس في خلق الله صدفة ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (القمر:49) ، ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (الحديد:22)، فكل شيء بقضاء الله وقدره .
قال الحسن البصري لتلاميذه : والله لو ضع يدي هذه اليمنى في اليسرى إنها بقضاء وقدر من الله .
ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر ، فقد كفر ، وقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في أركان الإيمان الستة : ( وأن تؤمن بالقدر خيره وشره )(2) ، وفي الحديث قوله (صلى الله عليه وسلم ) : ( احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، ولا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، أو قدر الله وما شاء فعل )(3) ، ومن أنكر القضاء والقدر فقد كفر .
( فصدفة ) يعني : كأنه ما كان لله سابق علم ، يعني : ما كأن الله قدر أن نلتقي .
بل قل : قدر الله كذا ، وقضى الله بكذا .
ومنها : قولهم ( الإنسانية ) ، و( الأخوة الإنسانية ) فلا يذكرون الأخوة الإسلامية ، لكن الإنسانية ، فيدخل عدو الله في هذه المظلة ، وإذا قلنا الأخوة الإسلامية خرج منها أعداء الله ( أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (المجادلة: من الآية22) ، ( أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (المجادلة: من الآية19) ، ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) (المائدة:56) ، ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (يونس:63) . وقال ـ سبحانه في سورة المائدة : ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) (المائدة: من الآية54) هذه صفات المؤمنين ، فأما أن نقول إنسانية ، فهذه ما سمعنا بها في آبائنا الأولين ، ولا في الكتاب ، ولا في السنة .
معنى ذلك : أن تدخل الملحدين ، والمعرضين ، وتجعلهم إخواناً لك ، لا أعداء .
ومنها : قولهم : ( شاءت الأقدار ) ، إنما أقول هذا ؛ لأنه يشعر بالاستقلالية في الأفعال والصفات ، وكذا لا نقول ( يا رحمة الله ) ولا ( يا غوث الله ) ولا ( يا لطف الله ) ، ولان هذه تشعر بالاستقلالية في الصفة ، بل ننادي الواحد الأحد ( يا الله ) ، يا رحمن ) ، ( يا رحيم ) ، ( يا أحد ) ، ( يا صمد ) ، ( يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) .
( فشاءت الأقدار ) خطأ إطلاقها ؛ لأن الله هو الذي قدر ، فالأقدار ليست فاعلاً بذاتها .
ومنها : قول السائل في كثير من الأسئلة التي تعرض ( ما رأي الدين ) ، الدين ليس له رأي ( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (لنجم:4) الدين قال الله ، وقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، فالدين ليس له رأي .
جاء رجل إلى ابن عمر ، فقال : يا ابن عمر ، أرأيت لو أنني زرت قبل أن أسعى ، أو سعيت قبل أن أطوف ، أرأيت لو فعلت كذا .
قال : اجعل أرأيت في اليمن .
ولذلك سموا فقهاء الأحناف ، أو بعضهم ، لما أكثروا من الرأي ( ارتيائيين ) ، وهذا الرأي ، لا يصيب دائماً ؛ لأنه متقلب ومتذبذب ، بل نعود إلى الكتاب والسنة .
ولذلك أمرنا الله عند التنازع ، أن نعود للكتاب والسنة ، لا إلى رأي أحد من الناس .
ومنها : قولهم ( اللهم اغفر لي إن شئت ) وهذه أفتانا فيها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال فيما صح عـنه : ( لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، بل ليعزم المسألة ، فإن الله لا مكره له )(1) . لأن الله يحب الملحاح في الدعاء ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) (الأنبياء: من الآية90) .
ومنها : تقديم بعض الألفاظ قبل السلام ، فإن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قال في مسند أحمد عن أبي أمامة : ( أولى المؤمنين بالإيمان بالله من بدأهم بالسلام ) ، والسنة عند المسلمين ، وعند أهل السنة : أن تبدأ بالسلام ، ولا تقدم كلاماً عليه ، كما يفعل بعض الناس ، ولكن لك بعد السلام أن تضيف ما شئت من العبارات التحية .
وقد عقد البخاري في الأدب المفرد (باب ) قول المضيف مرحباً . وقال : هل يقال : ( أهلاً ) فأورد حديث أم هانئ الذي في الصحيحين ) و( السنن ) و( المسانيد ) أنها دخلت على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فسلمت فقال : ( من هذه ؟ )
قالوا : أم هانئ .
قال : ( مرحباً بأم هانئ )(2) .
وقال عمر لعدي بن حاتم : حياك الله .
ومنها : قولهم ( العصمة لله تعالى ) ، تسأله في مسألة فيقول : أخطأت ، والعصمة لله ، وهذا خطأ ، قد نبه عليه كثير من العلماء ؛ لأن الله تعالى لا عاصم له ، والمعصوم يحتاج إلى عاصم ، والعصمة أمر نسبي ، يدخل فيها الاشتقاق ، والله لا يعصمه أحد من الناس ، فلا نقول : العصمة لله ، لكن نقول الكمال لله ـ سبحانه وتعالى ـ والجلال والعظمة لله ، والكبرياء لله ، أما العصمة لله ، فليس بصحيح هذا اللفظ .
يصح لك أن تقول : المعصوم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، أما الله ، فلا تقل العصمة لله ؛ لأن المعصوم يحتاج إلى عاصم ، والله لا يعصمه أحد .
ومنها : قولهم بعد التلاوة ، والانتهاء منها : ( صدق الله العظيم ) وهي بدعة ، لم يقلها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولا أصحابه ، ولم تأت في السنة ، ومعناها : صحيح واستخدامها خطأ وبدعة ، وإلا فالله يقول في آل عمران : ( قُلْ صَدَقَ اللَّهُ) (آل عمران: من الآية95) والله صادق ، وهو أصدق الصادقين ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً) (النساء: من الآية87) ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً) (النساء: من الآية122) لا أحد ، لكن استخدامها بعد التلاوة ليس بصحيح ، وهي بدعة ، فليعلم ذلك .
ومنها : قول الداخل للمسجد ، والإمام راكع : 0 إن الله مع الصابرين ) لينتظره الإمام ولا يرفع ! بل يفعل كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )(1) أو كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) . فتدخل بسكينة ووقار ، فإن أدركته في الركوع فبها ونعمت ، وإن لم تدركه فصلي ما فاتك ، ولا تقل : إن الله مع الصابرين ، أو تتنحنح ليسمعك ، وينبغي على الإمام : أن ينتظر الداخل ، إذا أحس بصوته ، بشرط أن لا يشق على المأمومين .
ومنها : رد التحية بغير السلام ، تقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول : أهلاً مرحباً ، وهذا مخالف لسنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ومن أفعال الجاهلية ، بل إذا سلم عليك تقول : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) (النساء: من الآية86) ، ( قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ ) (هود: من الآية69) فالتحية ترد بمثلها ، وبأحسن منها ، وهو السلام ، والأشنع من هذا أن يستبدل السلام كلية بغيره من التحايا كصباح الخير ، ومساء الخير ، ونحوهما .
ومنها : قولهم إذا قال الإمام : استووا ، قالوا : استوينا لله ، وهذا من الألفاظ غير الشرعية ، فلم يقل الصحابة وراء الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) استوينا لله .
وهاهنا : طرفة بهذه المناسبة ، وهي أن أحد الأئمة كان يصلي بأناس في الصحراء ، وكان من عادته أن يطيل أثناء تسوية الصفوف ، ليتأكد من استوائها ، وكانت الشمس حارة ذلك اليوم ، فقال لهم : استووا استَووا ، فرد عليه أحدهم وقال : قد استوينا ، أي من الشمس .
ومنها : قولهم : نويت أن أصلي كذا وكذا ، والجهر بهذا الكلام بدعة ، كقول أحدهم : نويت أن أصلي الظهر أربعاً ، والعصر أربعاً ، وقد نبه عليه ابن القيم في ( زاد المعاد ) في هديه ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة ، فلا يصح هذا .
ومنها : قول بعضهم في التحيات في الصلاة : اللهم صل على سيدنا محمد ، كلمة سيدنا لم تأت في النصوص ، وهي دخيلة ، ولا يجوز استخدامها هنا ، ولم يصح بها حديث يعني في التشهد .
أما كلمة ( سيد ) فاستخدمها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كما في البخاري في قوله في الحسن : ( إن ابني هذا سيد )(2)، ومثله قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( قوموا إلى سيدكم )(3) ، وفي قوله ـ سبحانه وتعالى ـ ( وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ) (آل عمران: من الآية39) .
والسيد هو كامل السؤدد وهي حرية برسولنا ( صلى الله عليه وسلم ) أما استخدامها في التحيات فلا حيث لم يثبت .
ومنها : التأمين برفع الأيادي بعد الخطبة يوم الجمعة ، فيخطب الخطيب يوم الجمعة ، اللهم أصلح ولاة المسلمين ، فيقولون : آمين مع رفع الأيدي ، وهذا لم يرد فيه حديث ، ومن عنده دليل فليأت به لنستفيد ، وه من البدع التي انتشرت ، ولم يرد إلا في مسألة واحدة وهي أثناء الاستسقاء من الخطيب ، لحديث قال : ( رفع ـ أي صلى الله عليه وسلم ـ فرفعوا أياديهم )(4) .
ومنها : قولهم بعد قول الخطيب ( فاذكروا الله يذكركم ) : لا إله إلا الله ! ويرتج بها المسجد ، وهكذا بعد قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (الأحزاب: من الآية56) فيصلون على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بصوت مرتفع .
فالواجب . الإنصات للخطيب ، والذكر ، والصلاة ، والتأمين ، تكون بالإسرار والخفية .
ومنها : قولهم ( والله ومحمد ) ، و( لولا الله وأنت ) وهذا شرك لفظي ، بل لولا الله وحده ، وما شاء الله وحده ، أو أن تستخدم حرف ( ثم ) ؛ لأنها للتراخي ( لولا الله ثم أنت ) أما الواو فلا لأنها للتشريك .
ومنها : سب الدهر ، وذم الأيام ، كقول شاعر الجاهلية :
لـحـا الله هـذا الـدهـر إنـي رأيـتــه بـصـيـراً بـمـا سـاء ابـن آدم مـولــع
وكقول أحدهم : ( قبحاً لهذا الزمان ) ، أو ( خيب الله هذا العهد ) أو ( هذا الدهر ) ، و( هذا الليل ) أو ( زماننا زمان قبيح ) ، أو ( هذا الزمان جر علينا النكائب ) هذا لا يصح فقد صح عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم ويسبني ابن آدم ويشتمني ابن آدم ، أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء ، وأما شتمه إياي فإنه يزعم أن لي صاحبة وولداً وما كان لي صاحبة ولا ولداً )(1) أو كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) .
فسب الدهر من أفعال الشرك ، ونسبة الأفعال إلى الدهر ، لا يصح فليعلم هذا .
ومنها : قولهم ( رجال الدين ) أو توزيع الناس إلى ناس للدين وناس للدنيا .
لا ، نحن للدين والدنيا ، ليس عندنا رجال دين ، بل رجال الدين في الكنيسة ، وهذه الكلمة مترجمة من الكنيسة ؛ لأنه في الكنيسة كان هناك رجال دين ، وكان هناك رجال دنيا ، أما نحن فعندنا قوله ـ سبحانه وتعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162) فالحياة والموت ، والليل والنهار ، وأعمالنا وتجارتنا ، ووظيفتنا ، وصلاتنا لله الواحد الأحد ، فليس عندنا رجال دين ، ورجال دنيا ، والذي لا يكون للدين فهو للدنيا ، والذي لا يكون لله فهو لإبليس ، فنسبة رجال دين ، وتخصيصها لنفر من الناس ليس صحيح .
ومنها : قولهم : ( مطوع ) و( مطاوعة ) وهي كلمة في اللغة العربية ليست مستقيمة ، ومبتذلة والطاعة لله ـ عز وجل ـ : ( قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) (النساء: من الآية46) فلا يصح استخدامها لنفر مخصوصين ، فليس هناك إلا طائع ، أو عاصي فاختر لنفسك .
ومنها : الدعاء برفع الأيدي جماعياً بعد أن يسلم الإمام ، وقد نص ابن تيمه ، وابن القيم بأنها من البدع المنتشرة عند المسلمين .
والدعاء بعد الفريضة وارد لكن لم يرد عنهم رفع الأيدي جماعياً .
ومنها : اتخاذ المصافحة بعد السلام عادة وسنة ، أو يقول معها : تقبل الله ، ولم يرد هذا عن السلف ، لكن لك أن تصافح أحداً من الناس قدم من سفر ، فرأيته في المسجد ، أما أن يتخذ عادة وسنة ، فلا .
ومنها : بعض الألفاظ الشركية ، التي انتشرت ، وقد نبه عليها كثير من الأئمة والخطباء ، مثل قولهم : (خذوه وشلوه ) ن وهي نسبة الأفعال والتصرف في الكون للجن ، وهذا شرك ، ولا يصرف إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً) (الفرقان:3) فنسبة هذه الأفعال لغير الله ـ عز وجل ـ شرك .
ومنها : مسألة الإرجاء ، وهي منتشرة بين الناس ، وهي مذهب بدعي ، فالمرجئة يقولون : الإيمان قول واعتقاد ، أما العمل فلا يدخل فيه الناس متساوون في الإيمان ، ولا يلزم على الإنسان أن يفعل صالحاً إذا آمن بل يكفيه إيمانه . قال ابن تيميه : ( لقد ترك المرجئة الإسلام كالثوب السافر ) أي : مزقوه .
فكثير من الناس خاصة الذين لم يقبلوا على الله ، أو ما عندهم قربة أو عندهم عمل صالح ، تقول له: صل.
فيقول : الله غفور رحيم ،
يفعل الكبائر ويقول : الله غفور رحيم !
وهذا مدخل شيطاني بل الإسلام قول ، واعتقاد ، وعمل ، ولذلك يقرن الله دائماً بين الإيمان والعمل ، فيقول في آيات كثيرة : ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) (الانشقاق: من الآية25) وذكر المؤمنين ووصفهم بصفات كثيرة يأتي على رأسها العمل الصالح : الصلاة ، الزكاة ، الحج ، الصدقة .. الخ .
فليحذر من هذا الإرجاء الجديد ، عباد الله ، ولينبه أهله لعلهم أن يفيقوا .
والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

